وين اختفى اسم الكاتب وتاريخ الارسال؟
سؤال عظيم يبحث عن إجابة بسيطة
وجدت تذكرة رخيصة إلى قبرص لا يتجاوز ثمنها كلفة عشاء اثنين، وهكذا وجدت نفسي في مكتبة «Academic & General Bookshop» في لارناكا، يعمل فيها رجل ستيني. لم يكن مجرد بائع كتب، بل قارئًا يتفاعل مع زواره ويتأثر أحيانًا حينما يحدِّثهم عن كتاب أعجبه.
مكثت ساعة في المكتبة، مستمتعًا بأحاديثه مع الزوار، ومتطفلًا أحيانًا إذا تحدثوا عن كتاب قرأته. امرأة دخلت لتخبره بأن ميلادها الثالث والسبعين كان في الأسبوع الماضي، وطلبت منه أن يوفر لها كتابًا في غضون شهر حتى تقرأه في رأس السنة.
بدوري طلبت منه أن يقترح لي كتبًا من الأدب القبرصي، فاقترح كتابين، ثم اقترح رواية لم يكتبها قبرصي لكنها تتحدث عنها، «جزيرة الأشجار المفقودة» لإليف شافاك. أخبرته بأني أعرف شافاك وقرأت لها لكني لم أقرأ هذه الرواية. بحث عن الرواية، لكنه استدرك من السيدة التي تعمل معه بأن آخر نسخة بيعت اليوم فاعتذر مني. بحثت في الإنترنت فوجدت الكتاب مترجمًا، واخترت أن أبدأ قراءتها في طائرة العودة التي أكتب منها الآن.
سامي البطاطي
ddd
dd
كيف تعلمت ترويض اللغة من أمي وكيليطو

الكاتب عبدالفتاح كيليطو / Babelio
يستهل عبدالفتاح كيليطو إحدى مقالات كتابه «لن تتكلم لغتي» بعبارة مجهولة المصدر تمنى لو كان هو صائغها «إننا ضيوف اللغة». استوقفتني العبارة لما تحمله من أسئلة محفوفة بإشكالات الهوية، فكيف نستطيع أن نقيم علاقة مستقرة مع اللغة، وكيف لهذه اللغة أن تمنحنا كامل ضيافتها وهي قلقة من نيتنا في البقاء أو الرحيل؟ وهل اللغة فعلًا هي من يضيِّفنا أم نحن في الحقيقة من يضيِّفها؟
هذا التوتر كان يقلق كيليطو وربما دفعه في المقالة نفسها إلى أن يعترف بهاجس يسكنه: «لا تتكلم لغتي». وأضاف برؤية استبصارية قطعية «ولن تتكلمها». هذا التأكيد يثير الإعجاب لعدة أسباب، فكيليطو المُفلِق اللسان والثنائي اللغة الذي يكتب بيده اليمنى العربية واليسرى الفرنسية ويتحدث بطلاقة اللغتين كلتيهما إضافة إلى العامية المغربية هو من أصدر حكمًا مدهشًا وغريبًا وفاحشًا، على حد تعبيره، كان بالإمكان التغاضي عنه والإبقاء عليه مضمرًا. فأي لغة إذن حلَّ عليها كيليطو ضيفًا؟ وأي لغة يقصدها باستحالة الكلام فضلًا عن استحالة الضبط والتمكين؟
منذ زمن بعيد انتقلَت أسرة والدتي من منطقة سوس جنوب المغرب إلى ضواحي الرباط العاصمة، كانت الأسرة ذات أصول أمازيغية، لكن اللسان جرى بما يمليه المكان؛ فتحدثت أمي العربية أو الأدق العامية العربية السائدة في المنطقة. وفي هذه القرية الصغيرة تعرفَت إلى أبي القادم من جبال الريف الأمازيغية وتزوجته، وبحكم العادة والتقاليد انتقلت ملتحقة بزوجها من أرضها العربية إلى أرض أمازيغية الهوى والثقافة واللسان. أدركت والدتي على رغم حداثة سنها أنها لم تحل ضيفة على المكان وحسب بل على اللغة أيضًا، وأن هذه اللغة أكرمت وفادتها كما يكرَم الضيف ثلاثة أيام، وبعدها لم تستطع لغة المكان صبرًا أمام جهل أمي، فبدأت التململ ثم الإقصاء الكلي.
ربما لا تعرف أمي توني موريسون ولم تلتق يومًا بحكاياتها، لكنها أدركت بذكائها الفطري ما أجملَته موريسون حين قالت إن اللغة قد تكون مجالا خصبًا للحرب كما قد تكون مجالًا للاضطهاد والمقاومة. فمهما حاولت اللغة أن تبتسم للغريب وتتفضل عليه ببعض الكلمات والمفردات فهي حتمًا ستواجه جهله بالرفض والاضطهاد ثم نفيه من مجال التواصل.
بدأت أمي تعي تمامًا أن عليها أن تتجاوز ضيافة لغة المكان إلى السعي نحو امتلاك اللغة ومزاحمة أهل الدار، وقد وجدت لديهم القبول أحيانًا والنبذ المشبع بالخوف أحيانًا أخرى. لكنها استطاعت بعد مدة وجيزة أن تصبح المضيفة عِوَض الضيفة وتمردت على حكم الاستحالة الذي يشبه ذاك الذي فرضه كيليطو، واستطاعت أن تتكلم الأمازيغية، أو بالأحرى أن تزيح مضيفتها السابقة العربية وتعود إلى لغتها الأم.
إنَّ ما حرك أمي لحظتها لم يكن الرغبة في السيطرة أو حيازة ما يملكه الآخرون، ولم تشكل تهديدًا كما يراه كيليطو، بل حرّكتها الرغبة في الفهم والبقاء وسط الحكاية لا على هامشها. وأظن هذا ما يحركنا جميعًا حين نتحدث لغات سوانا: نتجاوز الفضول إلى صنع الحدث ونبلغ ذلك متى أصبحنا أسياد اللغة لا ضيوفًا عليها وحسب.
لم تكن أمي وحدها مَن تمكنَت من القبض على اللغة ومنعها من الفرار، بل فعَلها أيضًا كيليطو حين تمكن من ترويض اللغة الفرنسية وضبْط مجالها والسيطرة على تفاصيلها، فكتب بها وحاضر ودرَّس وفق قوانينها. فالفرنسية ليست لغة المغاربة الأصلية، بل ينص الدستور على أن العربية والأمازيغية هما الرسميتان، وأي لغة أخرى ستحل ضيفة وسنكون نحن المُضيفين، كما خلص إلى ذلك كيليطو حين وصف اللغة الأخرى بأنها «ضيفة مشاكسة عنيدة تحل عنده دون استئذان، فتتملكه وتسكنه على رغمه. إننا مسكونون باللغة بالمعنى السحري للكلمة».
إن ما يخفيه هذا الحكم الجائر «لن تتكلم لغتي» هو التناقض الذي نعيشه في مواجهة الآخر. متى تحدث أحدهم بالعربية أو بلغاتنا المحلية فنحن نتربص به حذرين يحركُنا شعوران متناقضان: فمن جهة نبتهج سعداء بهذه المحاولة التي يُقدم عليها الآخر فينطق كلماتنا بتعثر نستلذ أحيانًا بما يرافقه من معاناة، ونرحب بهذا الغريب الذي يلقي التحية بالكلمة فنسارع إلى مساعدته وإعانته على إكمال جُمَله وتوضيح ما أغفله، ومن جهة أخرى نرتاب من محاولته ونعدها اقتحامًا لمجالنا وسلبًا لسيطرتنا وانتزاعًا لأهم ما يميز هويتنا.
وقد ذكر كيليطو مثالًا على هذا الوضع المزعج لـ«مالك اللغة» أمام «الغريب». فحين صادف صديقة أمريكية تجيد العامية المغربية وقف أمامها مندهشًا مغتاظًا من اللسان الذي سَرَق منه لغته وحزينًا معاتِبًا هذه اللغة التي انسلت بخفة من بين يديه. لكنه سرعان ما ابتهج حين أدرك أنه مهما تمكنَت المرأة من لغته فلن تتحدث بها، ويقصد كيليطو بهذا التأكيد أن ضبط لغةٍ ما دون سياقها الثقافي قد يشجع المتحدث على أن يطأ أرضًا وعرة قد يصيبه أحد ألغامها.
فمثلًا: هذه المرأة التي نجهل معتقدها ذكرت ضمن حديثها كلمة «وْاللَّهِيلَا»، وهي كلمة عامية تحتمل أكثر من تفسير حسب سياقها الدلالي، لكنها تضم في جميع الحالات كلمة «الله»؛ فهل كانت الأمريكية تدرك ذلك؟ قد تثبت هذه المفارقة البسيطة ما أكده كيليطو في كتابه «حبر خفي»: «لن تتكلم لغتي تكمن في التفاصيل.»
هذا السحر الذي يتملكنا متى داعب لسانُنا لغات ولهجات أخرى لا يخلو من خطورة تظهر في تأثير الكلمة التي نضيِّفها على تفكيرنا؛ فالكلمة لا تأتي خالية الوفاض بل تحمل ثقلها وسياقها الذي يضفي ظلاله على ما نفكر به ونكتبه.
يطيب لبعض الأصدقاء أن يعلقوا على ما أكتبه قائلين إنني أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية، ودائمًا أرد على هذا الاتهام اللطيف بأني مثل أمي وكيليطو مُفلِقة اللسان ولستُ فردًا بل جمع: أفكر بكل اللغات التي ضيَّفتني وضيّفتُها عبورًا من الأمازيغية إلى العربية والفرنسية، ثم بشكل أخف الإسبانية والإنقليزية، لكني في النهاية أكتب بما اخترته - وهي العربية.
فلا أرى إشكالًا أو غموضًا في هذه العملية، ولا أفكر بالتقنية التي ساعدتني على إنجاحها؛ فكل ما يهمني لحظة الكتابة أن يصل المعنى إلى القارئ وإن كنتُ أخاطر بأن أكتب إليه رسالة غرامية باستخدام القاموس كما اقتبس كيليطو من سيوران.
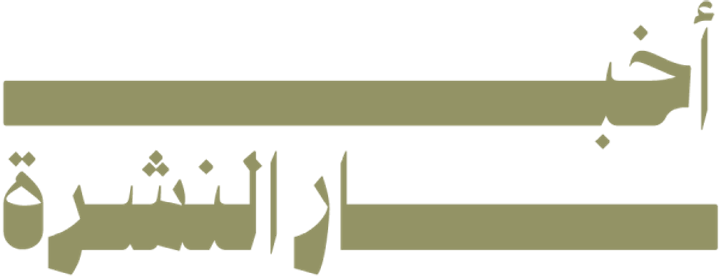
صدر حديثًا عن دار الآداب رواية «الكلمة الأجمل» للكاتبة الأيسلندية أودور آفا أولافسدوتير، ونقلها إلى العربية محمد آيت حنا. تدور الرواية حول تقصي قابلة للمسار الذي يقطعه الإنسان من ظلمات الرحم إلى ظلمات القبر.
صدر حديثًا عن دار أثر للنشر والتوزيع الرواية الحاصلة على جائزة البوكر لعام 2021 «الوعد»، للكاتب الجنوب الإفريقي ديمون غالغوت. تتبع الرواية صراعات عائلة بيضاء وسط العواصف التي مرّت بها جنوب إفريقيا من الفصل العنصري حتى تنحي جيكوب زوما.
أعلنت جائزة «سيف غباش بانيبال» (Saif Ghobash Banipal Prize) للترجمة الأدبية من العربية إلى الإنقليزية قائمتها القصيرة لعام 2023، وضمت رواية «العمامة والقبعة» لصنع الله إبراهيم، ورواية «السيد نون» لنجوى بركات، وروايتي «ملك الهند» و«Firefly» لجبور الدويهي، ورواية «ماذا تركت وراءك؟» لبشرى المقطري، و«طائر الرعد» لسونيا نمر.
تصدر قريبًا عن دار الساقي المجموعة القصصية «موتٌ في منتصف الصيف» للكاتب الياباني يوكيو ميشيما.


من علي حسين:
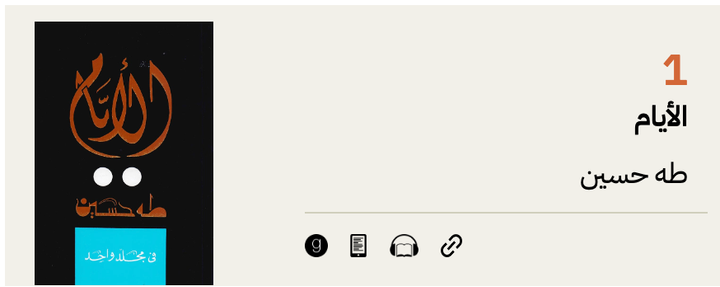
في كانون الأول من عام 1926 نشرت مجلة «الهلال» الحلقة الأولى من كتاب مسلسل بعنوان «الأيام» يروي فيه طه حسين فصولًا من سيرته الذاتية وما جرى له في طفولته وصباه وشبابه.. بعد ذلك نُشرت المقالات في كتاب من ثلاثة أجزاء يستعرض حياة طه حسين بالوصف والتسجيل، ويُعد شهادة على العصر الذي عاش فيه «عميد الأدب العربي». كتب طه حسين «الأيام» وهو في السابعة والثلاثين، وطُبع الكتاب أكثر من خمسين طبعة وما زال يُطبع ويجد قارئًا جديدًا كل يوم، وهو يقول لغالي شكري: «ليس الغرض من «الأيام» أن أصف حياتي، وإنما كنت أريد أن أدرس حياة المجتمع المصري في ذلك الزمان».

جرت عادة مؤرخي الفلسفة على أن يصفوا المدينة التي صورها أفلاطون في كتابه «الجمهورية» بأنها أول ما عرفه العالم من مدن فاضلة، وكانت غايته الأساسية في محاورة «الجمهورية» البحث عن العدالة وشروط تحقيقها، وهذا الموضوع يستغرق أكثر من ثلاثة أرباع الكتاب، وفي الربع الأخير يعرض أفلاطون مصادر الفساد التي تصيب الدولة والمواطنين وكيف تتدهور الدول فتتحول إلى صورة فاسدة من الحكم.
يدور الحديث في الجمهورية بأسلوب قصة يرويها سقراط لمستمعيه، وهم خليط غير متجانس، منهم السفسطائي ومنهم الباحث عن الحقيقة ومنهم من يؤمن بالديمقراطية ومنهم من يرى في الحرية ضررًا على الاستقرار. يؤكد الدكتور فؤاد زكريا في مقدمته للترجمة العربية لـ«جمهورية أفلاطون» أن الهدف الرئيس لأفلاطون هو وضع فن رفيع لتدبير شؤون النفس.

نشرة أسبوعية تتجاوز فكرة «أنت تستطيع» إلى «كيف تستطيع» تحقيق أهدافك وتحسين نمط حياتك.